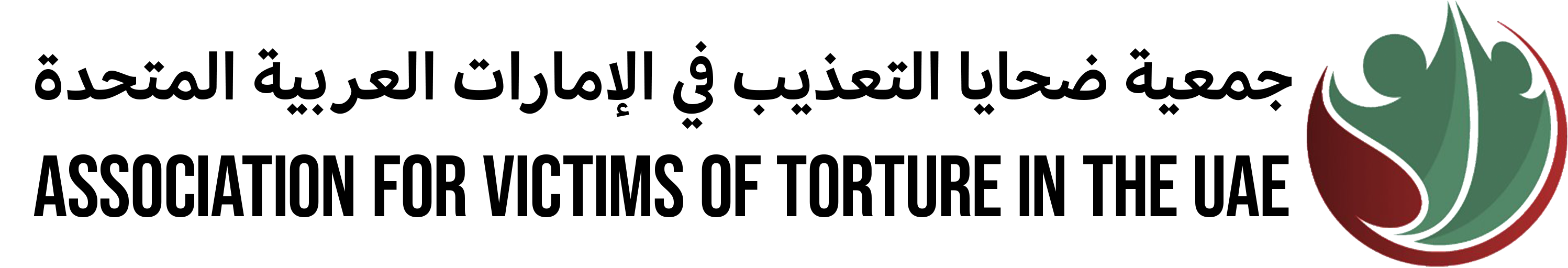رغم وجود شبكة واسعة من المؤسسات والهيئات الرسمية وشبه الرسمية التي تُعنى ظاهريًا بحقوق الإنسان في دولة الإمارات، فإن المشهد العملي يكشف عن فجوة كبيرة بين الهياكل المعلنة والممارسات الواقعية. إذ يظهر أن هذه الكيانات، على كثرتها وتنوعها، تعمل في إطار محدود يخضع لاعتبارات سياسية وأمنية، ما يجعلها أقرب إلى أدوات تجميلية (Tokenistic) تُستخدم لتعزيز الصورة الدولية للدولة، بدلًا من ضمان حماية الحقوق والحريات على أرض الواقع.
جمعية مناهضة التعذيب في الإمارات أجرت بحثًا أوليًا عن هذه الشبكة مع تقييم لمدى فاعليتها واستقلالها، لتخلص إلى أنها مجرد جزء من أدوات تحسين الصورة، بينما تغيب الإرادة السياسية عن أي تدابير فعلية ملموسة لحماية حقوق الإنسان في البلد أو تحقيق الانتصاف.
ويمكن تقسيم هذه الجهات والهيئات إلى مجموعة من الفئات على النحو التالي:
أولًا: الجهات الاتحادية واللجان الوطنية
تشمل هذه الفئة كيانات مثل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى دوائر ضمن وزارات معينة كالخارجية والداخلية والموارد البشرية.
ويتضح من خلال تتبع دور هذه الفئة رغم ما تطرحه من شعارات وآليات، فإنها تعاني من غياب الاستقلالية،إذ إن معظم هذه الهيئات مرتبطة مباشرة بالسلطة التنفيذية أو تخضع لإشراف حكومي كامل، مما يقوّض قدرتها على التحقيق في الانتهاكات التي قد ترتكبها أجهزة الدولة نفسها.
كما أن هذه الآليات تتسم بطابع الانتقائية في القضايا، حيث يتركز النشاط في مجالات منخفضة الحساسية السياسية (مثل مكافحة الاتجار بالبشر في صورته الجنائية) بينما تُهمل القضايا الجوهرية المتعلقة بحرية التعبير، وحقوق المعتقلين السياسيين، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
بالإضافة الى ما سبق يلاحظ ضعف الاستجابة للشكاوى، فعلى الرغم من وجود أرقام هواتف وبريد إلكتروني ونماذج إلكترونية، إلا أن تقارير منظمات حقوقية دولية توثق أن هذه الشكاوى إما لا يُرد عليها، أو يُكتفى بتحويلها إلى جهات أمنية.
مثال توضيحي: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI) التي يفترض أن تكون مستقلة وفق “مبادئ باريس” تم تأسيسها بمرسوم اتحادي وتعيين أعضائها من قبل الحكومة، ما يتناقض مع المعايير الدولية للاستقلالية.
ثانيًا: الجهات المحلية في الإمارات المختلفة
تشمل هذه الجهات إدارات حقوق الإنسان في شرطة دبي وشرطة أبوظبي، وهيئات تنمية المجتمع، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
ويلاحظ من خلال تتبع نشاط هذه الجهات طغيان الطابع الأمني، فإدارات حقوق الإنسان في الشرطة تعكس تضاربًا في المصالح، حيث لا يمكن لجهة ذات سلطة ضبطية أن تكون حكمًا محايدًا في شكاوى الانتهاكات ضد الشرطة نفسها، كما لا يوجد أي معلومات حول التحقيق في شكاوى تلقتها هذه الجهات وأعلنت عن نتائجها.
كما تتسم بطابع التعامل الخدمي لا الحقوقي، إذ تركز هذه المؤسسات غالبًا على الخدمات الاجتماعية أو الدعم الإنساني المحدود، دون الولوج إلى جذور الانتهاكات أو مساءلة المتسببين.
ناهيك عن غياب الشفافية المنخفضة، حيث تغيب أي تقارير علنية مفصلة عن نتائج الشكاوى أو التدخلات أو المساءلة عن انتهاكات لمأموري الضبط أو عناصر الشرطة، بما في ذلك شكاوى التعذيب.
ثالثًا: الكيانات شبه الحكومية والمقربة من السلطة
مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز إيواء أبوظبي (Ewaa)، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وكلها هيئات يمكن ملاحظة جملة من الإشكاليات بشأنها تشمل: الاعتماد المالي والإداري على الحكومة، ما يجعلها في الغالب تعمل ضمن الخطوط الحمراء المرسومة، والاستخدام الدعائي، إذ إن كثيرًا من أنشطتها موجه للترويج الخارجي، لا لمعالجة الملفات الحرجة في الداخل.
كذلك يلاحظ فيها غياب التمثيل المستقل للمجتمع المدني، على سبيل المثال جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تُعرف بمواقفها المؤيدة لخطاب الحكومة وتجاهلها شبه الكامل لملفات السجناء السياسيين أو حتى التفاعل مع الملاحظات والتوصيات والآراء الصادرة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
رابعًا: قنوات الإبلاغ والشكاوى
على الورق، هناك منظومة واسعة من الأرقام الساخنة والبريد الإلكتروني والتطبيقات، مثل:
• 80084 لحقوق العمال.
• 800-SAVE لضحايا الاتجار بالبشر.
• خطوط نجيد، الأمين، أمان للشرطة.
لكن فعالية هذه القنوات منعدمة، وكلها تبدو مجرد جزء من الدعاية التي تمارسها السلطات لإظهار الجانب الإنساني، في حين يشك البعض بأن تكون فخ للمشتكين للإيقاع بهم، وذلك للأسباب التالية:
1. الخوف من الانتقام: بيئة قانونية وأمنية لا تحمي المُبلّغين.
2. غياب الشفافية في المتابعة: نادرًا ما تُنشر بيانات عن عدد الشكاوى، أو مسار التحقيق، أو النتائج.
3. الإطار القانوني القمعي: قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وقوانين النشر تُستخدم لتجريم الانتقاد، ما يثني الأفراد عن التبليغ في القضايا الحقوقية الحساسة.
خلاصة القول، أنه رغم اتساع قائمة الكيانات المعنية بحقوق الإنسان في الإمارات، إلا أن القاسم المشترك بينها هو الطابع الحكومي المباشر أو غير المباشر، وغياب المساءلة المستقلة، مع التركيز فقط على ملفات حقوقية غير سياسية أو “مقبولة” دوليًا، وتجاهل القضايا البنيوية مثل حرية الرأي، والحق في التجمع السلمي، ووقف الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعليه؛ فإن هذه المعطيات تجعل من الهيكل المؤسسي الحالي أقرب إلى واجهة سياسية تُستخدم لتخفيف الضغوط الدولية، بدلًا من كونها منظومة حقيقية لحماية الحقوق والحريات.